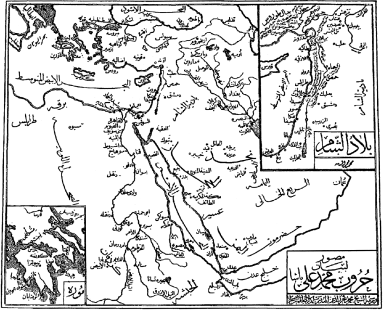بعد إخلاء الحملة الفرنسية البلاد ورجوعها إلى فرنسا ابتدأت جماعة المماليك تشْرئبُّ أعناقها لأن تقبض على زمام الأمور في البلاد كما كانت من قبل، في حين أن الباب العاليَ كان يطمح إلى طرد المماليك من الديار المصرية، واسترجاعها بعد أن اغتُصبت منه مدة من الزمان، لكن المقادير جاءت بعكس ما أمل الفريقان؛ إذ أراد الله أن تكون نصيبًا لمحمد علي.
بدأ النزاع بين الباب العالي والمماليك عندما أراد الأول أن يستقل بالسيادة في مصر، فاستخدم للتغلب عليهم طريقة غير مقبولة؛ وذلك أن القبطان حسين باشا دعا البكوات العظام من حزب مراد بك إلى معسكر بوقير، بعلَّة التفاوض معهم في صيرورة حكومة مصر، فكان معظمهم غير مرتاح البال إلى هذه الدعوة، إلا أن خوفهم من نزع السلطة كلها من أيديهم حملهم على تلبيتها، وطَمأن خاطرهم قربُ معسكر القائد «هتشنسون» الإنجليزي.
قابلهم الباشا القبطان بتهلُّل واستبشار وأكرم مثواهم، ثم دعاهم إلى ركوب زورق له لزيارة القائد الإنجليزي، بحجة أنه يريد أن يتفاوض معه أيضًا، ولما بعدوا عن الشاطئ قليلًا لحقه زورق يحمل بعض الأوراق، فاستأذنهم ليقرأها على انفراد وترك الزورق بمن فيه من البكوات؛ فظهر لهم عند ذلك أنه يريد بهم سوءًا، فأمروا النواتي بالرجوع فامتنعوا وأطلقوا عليهم النار، فقتلوا ثلاثة وجُرح عثمان بك البرديسي واثنان آخران، فلما علم القائد الإنجليزي بذلك استشاط غضبًا، فاعتذر له الباشا القبطان بأسباب واهية. وفي الوقت الذي حدثت فيه تلك الحادثة عند ساحل البحر كانت تمثَّل الرواية نفسها في القاهرة، وقد احتمى معظم من بها من البكوات بالمعسكر الإنجليزي فيها، فأسعفهم القائد «رَمْزي» رغم إلحاح الصدر الأعظم في تسليمهم إليه؛ فكانت هذه الحادثة مدعاة إلى اشتعال نيران الحقد في صدور المماليك، وقد زادها لهيبًا جعل «محمد خُسْرُو» مملوك الباشا القبطان واليًا على مصر في (ربيع الأول سنة ١٢١٦ﻫ/يوليو سنة ١٨٠١م)؛ حصَّل له القبطان ذلك المنصب بتوسط الصدر الأعظم يوسف باشا لدى الباب العالي.
ويُعتبر خسرو باشا الوالي الجديد على الديار المصرية من أشهر رجال الترك في القرن الثالث عشر، وكان ذا حُظْوة عظيمة لدى السلطان، وقد خاصم محمد علي مدة نصف قرن كان في أثنائها عدوَّه المبين لأسباب سنذكرها في موضعها. وكان من الذين يُعتدُّ برأيهم في جسام الأمور ومعضلات السياسة كما سيجيء، ولا يُعزَى فشلُه في مصر إلى قلة الذكاء والشجاعة، بل لأنه ابتدأ حروبًا داخلية في وقت كانت فيه خزانته خلوًا وجيشه غير مدرب، على قوة عظيمة من فرسان المماليك الذين كان في قبضتهم خيرات البلاد وفيضُها.
ومن العبث أن نتجاهل ما كان للمماليك من المزايا العظيمة التي يمتازون بها على الأتراك في حربهم لهم؛ وذلك لأنهم التحموا بالجيوش الفرنسية أكثر من الأتراك، فاقتبسوا من طرقهم الحربية ما زادهم فَوْقًا على الأتراك، ذلك إلى أنهم يعرفون البلاد أكثر من جنود الترك الذين وصلوا إليها حديثًا، وأنهم كانوا لا يزالون أصحاب النفوذ والسلطان في البلاد.
فلما أراد «خسرو» مطاردتهم ونزْع البلاد من أيديهم، ظهرت كل هذه العقبات أمامه، فضلًا عن أنهم القابضون على أَزِمَّة الأحكام في المديريات، فأصبح القصد إذنْ من حربه لهم انتزاعَ البلاد من قبضتهم؛ فأرسل لذلك «طاهر باشا» قائد الألبانيين بجيش كان نصيبه الخيبة والفشل، وطارده عثمان بك البرديسي قائد المماليك من الوجه القبلي إلى الوجه البحري حتى ساحل البحر. ولما وصلت أخبار هذه الهزيمة إلى خسرو أعدَّ مددًا أرسله بقيادة محمد علي، وكان ممن نال ثقة خسرو في هذا الحين، إلا أن عثمان بك بادر إلى مناجزة الجيش التركي قبل أن يصل إليه المدد الذي كان يقوده محمد علي، وبدَّد شمله.
فلما علم خسرو بالهزيمة الثانية وجَّه لومًا إلى الألبانيين وخاصة إلى محمد علي، وأراد أن يحاكمه على تقصيره أمام مجلس عسكري، وكان غرضه بذلك اغتياله، فامتنع محمد علي عن الحضور، ومن هذا العهد ابتدأت بذور العداوة تنبت بين هذين الرجلين؛ تلك العداوة التي فتَّت في عضد الدولة ومزَّقت أحشاءها كلَّ ممزق.
وبعد الهزيمة الأخيرة أبت عساكر الترك الحرب كل الإباء لتأخر رواتبهم، وثاروا وحاصروا الخزانة ونهبوا وسلبوا القاهرة، فاعتصم خسرو بالقلعة، وأصلى العصاة منها نار حامية، فأراد إذ ذاك طاهر باشا قائد فرقة الألبانيين — وعددهم ٥٠٠٠ — أن يتوسط بين خسرو والعصاة، فأبى خسرو وساطته، فانضم إلى العصاة عليه، ولما لم يجد خسرو لديه حينئذٍ جندًا تحميه ولَّى هاربًا إلى دمياط، وبقي بها ينتظر فرصة يسترد بها ما فقده.
ولما علم طاهر بذلك جمع رءوس العلماء وأشراف العاصمة وشاورهم في الأمر، فرضُوا أن يكون نائبًا عن الوالي عليهم، فأعلن أنه هو الحاكم على مصر حتى يولِّيَ الباب العالي خلفًا لخسرو باشا، وذلك في (صفر ١٢١٨ﻫ/مايو ١٨٠٣)، وكان من سوء طالع طاهر باشا أنه وقع في نفس الحيرة التي وقع فيها خسرو؛ إذ لم يمكنه دفع مؤخر رواتب الجند، وبعد ٢٢ يومًا من قبضه على زمام الأحكام تألَّب عليه الجند، واغتاله ضابطان — موسى أغا وإسماعيل أغا — بعد أن تظلَّما له من تأخير رواتب الجنود.
فأصبح محمد علي — بعد هرب خسرو وقتل طاهر — رئيس الأجناد غير المماليك من الأرناءوط وغيرهم؛ لأن رتبته في الجيش كانت تلي رتبة طاهر باشا، ولأنه كان محبوبًا لدى العلماء والأهالي لما كان يُبديه من العطف والحنان عليهم، فحاز رضاهم بدفاعه، وكاد يعلن نيابته عن الوالي لولا أن رأى مركزه لا يقل خطرًا عن مركز طاهر؛ لعدم قدرته على دفع مؤخر رواتب الجند، وعلى مقاومة خسرو باشا والمماليك معًا بمن كان تحت إمرته من الألبانيين؛ فرأى أنه من الحكمة والكياسة أن ينضم إلى عثمان بك البرديسي هو ومن معه، فتحالفا ونصَّبا إبراهيم بك الكبير نائبًا عن الوالي العثماني، لكبر سنِّه ومكان احترامه عند المماليك، وطردوا الإنكشارية من مصر.
وكان بمصر وقتئذٍ «أحمد باشا» والي المدينة وينبع، مارًّا بها، يستمدُّ واليها ويتأهب للخروج إلى منصبه، ويؤلِّف حملة يكافح بها الوهابيين؛ فاشترك في هذه الحوادث وفي مقتل طاهر باشا، وجعل نفسه واليًا على مصر، أو على الأقل نائبًا عن خسرو ريثما يحضر من دمياط، وكاد يتم له مراده لولا مناصبة محمد علي وإبراهيم بك له وعدم اعترافهما له بأي حق في التدخُّل في شئون البلاد. ولم يشعر بسلطته أحد؛ لأنها لم تَدُمْ أكثر من يوم وليلة، ثم جاءه التقليد من الأستانة بنيابته عن الوالي حتى يحضر، ولكن بعد فوات الفرصة؛ فإنهم طردوه وباقيَ الإنكشارية من مصر، فخرج إلى الحجاز.
ثم إن البرديسي ومحمد علي تعاونا على إخضاع المماليك الثائرين الذين كانوا يهددون العاصمة، وبعد أن تم لهما ذلك عمِلا على بت الأمر في قضية خسرو؛ فأعدَّ لذلك عثمان بك البرديسي جيشًا بريًّا، أما محمد علي فإنه جهَّز أسطولًا صغيرًا ونزل به إلى دمياط، وكان قد أخذ لذلك عدته، وبعد مناوشات خفيفة أخذ خسرو سجينًا إلى القاهرة.
ولما علم الباب العالي بسير الأحوال في مصر استولى عليه الخوف والقلق، واتضح له جليًّا أن خسرو أصبح غير لائق لولاية مصر، فأصدر عهدًا بتولية «علي باشا الجزائري»، ونزل هذا الوالي الجديد بالإسكندرية في (ربيع الأول سنة ١٢١٨ﻫ/٨ يوليو سنة ١٨٠٣م)، فرأى أنه لا يمكنه مقاومة البرديسي ومحمد علي بحد السيف، فاتفق معهما ظاهرًا، على حين أنه كان يعمل في الخفاء على هدم قوتهما وتكوين حزب وطني مصري يناهض المماليك، ولكن من سوء حظه أن بعض مراسلاته مع السيد «السادات» وقعت في يد البرديسي — وكان هذا ضيفًا عنده — فاحتال البرديسي في قتله، وتم له ذلك في (شوال سنة ١٢١٨ﻫ/يناير سنة ١٨٠٤م).
وفي الشهر التالي لمقتل علي باشا الجزائري ظهر رجل ذو سطوة وبأس وأعوان كثيرين، وهو «محمد بك الألفي» الذي يُعَدُّ من أكبر المماليك في الديار المصرية؛ وذلك أنه رجع من إنجلترا بعد أن مكث بها سنتين، وكان قد سافر إليها عام (١٨٠٢م) مع الحملة الإنجليزية، وسبب سفره أن الإنجليز كانوا قد عاهدوا المماليك في واقعة سنة (١٨٠١م) أن يأخذوا بناصرهم، ليتخذوهم صنائع وأعوانًا لهم بمصر إذا اقتضى الحال تدخلهم في شئونها مرة أخرى. فلما رجعت الحملة صار يتغنى قوادها بفروسية المماليك وشجاعتهم وخدماتهم، فسهل على الأمة الإنجليزية تعزيز هذا الاتفاق، وعزموا على مساعدة الألفي وحماية المماليك. فلما وصل إلى السواحل المصرية علم أنه لا يمكنه الوصول إلى ضالته إلا بتوحيد قوى المماليك وجعْلهم تحت حماية الإنجليز، وكان ذلك لا يتم له إلا بالاتحاد مع البرديسي عدوه العنيد، وإبراهيم بك الكبير. فلما نزل عند بوقير قابله أعوانه بكل حفاوة وإكرام، وإذ كان في ريبة من أمر البرديسي اتخذ مسكنه في دمياط، وأصدر الأوامر إلى أتباعه بالاجتماع في ضيعته بالجيزة، ومعهم كل ما يمكن جمعه من العدة والعدد، على أن يلحق بهم بعد.
إلا أن وصوله إلى الديار المصرية لم يَرُقْ في نظر كلٍّ من البرديسي ومحمد علي؛ لأن الأول رأى أن من الخطل أن تكون نتيجة خلعه واليَيْن وقتله ثالثًا أن يشاركه في السلطة مناظر كان بعيدًا عن الديار أثناء حربه معهم، وفاته أنه لو اتحد مع الألفي كما اتحد مع إبراهيم بك لاستعادوا سلطة المماليك في مصر؛ لأن محمد علي غريب عن البلاد وهو وحده لا يقوى على مقاومتهم، ولكن تدبير محمد علي ودهاءه وسعوده كلها حالت دون اتفاقهم، خصوصًا أنه رأى أن البرديسي في قبضته ولا داعيَ قط لإشراك مملوك آخر في حكم البلاد؛ فاتفق الاثنان على أن يتخلصا من محمد الألفي، وفعلًا حاصر محمد علي ومن كان معه من الألبانيين قصرَه في الجيزة وأخذ أتباعه على غرة، وقتل منهم خلقًا كثيرًا، وفر الباقون. أما البرديسي فسار بجيشه ليفتك بالألفي في طريقه إلى القاهرة، فقابله بالمنوفية هو وحاشيته، فأفْلت الألفي من يده وهرب إلى سورية، أما من كان معه فقتل معظمهم وسلب كل ما معهم من المتاع والمال.
اتَّبع محمد علي أثناء كل هذه المكافحات التي ناصب بها السلطان ومحمد الألفي خطة أظهرت ما كان عليه من الدهاء والحكمة؛ إذ إنه اختفى وراء الستار، وأظهر البرديسي بمظهر العاصي في وجه السلطان والمهاجم للألفي بك، مع أن محمد علي كان يساعده في جباية الأموال اللازمة للجيش الذي كانا يستظهران به على من ينازعهما السلطة.
ولما هرب الألفي من الديار المصرية طلب محمد علي من البرديسي رواتب الجند، وأنذره أنه إذا تأخر اضطُر إلى تركه وحيدًا وساعد الترك عليه وانضم إليهم، فلم يسع البرديسي إلا تلبية طلبه، وبذل كل جهده في جباية ما يلزم من المال بالقوة من التجار، فأثار غضب الأهالي وهيَّجهم، ولا سيما أن ذلك أعقب ضرائب فادحة جمعتها الحكومة واستَعمل الجباة في استخراجها العنف والشدة معهم؛ إذ كانوا يضربون من يمتنع منهم، وقد يقتلونه.
فانتهز هذه الفرصة محمد علي وانسلخ من البرديسي، وأظهر استياءه لجمع هذه الضرائب الفادحة، ووعد الأهالي بالأخذ بناصر الذين يعارضون في جمعها، فمال إليه الناس، وأصبح محبوبًا عند عامة أهل القاهرة وأشرافها، ولَمَّا وثق من أن الرأي العام يؤيِّده، وأن هذه أحسن فرصة للقضاء على سلطة البرديسي والتخلُّص منه ومن أتباعه، قام في فجر يوم (٣٠ ذي القعدة سنة ١٢١٨ﻫ/١٢ مارس سنة ١٨٠٤م) هو وجميع من التفَّ حوله من الجند وحاصروا قصر البرديسي — الذي كان محصنًا بالمدافع — فتمكَّن محمد علي من رَشْوِ رجال مدفعية البرديسي فحوَّلوا مدافعهم على سيِّدهم؛ إلا أن البرديسي وإبراهيم بك الكبير اقتحما الطريق وفرَّا هاربَين إلى بلاد سورية.
فصفا الجو عندئذٍ لمحمد علي، وأصبح صاحب الكلمة النافذة في القاهرة، إلا أنه رأى الفرصة لم تَحِنْ بعدُ للقبض على زمام الأمور في الديار المصرية للأسباب الآتية:
- (١)
أنه رأى لا بد من أن عثمان بك البرديسي ومحمد بك الألفي سيتفقان على مناوأته، وهو لا يقوى على مكافحتهما متَّحدَين.
- (٢)
أن أتباعه من الجند لم تكن إلا عصابة صغيرة من الألبانيين لا تقوى على منازعة جميع الماليك.
- (٣)
أنه كان يعتبر في هذه الفترة خارجًا على الدولة لاشتراكه في خلع خسرو، وأن الدولة ربما أرسلت جيشًا لقهره والضرب على يده.
فأراد أن يتخلص من هذا المأزق الحرج بإذاعته أنه يريد تحرير القطر المصري من جور المماليك وعسفهم، حتى يكون قد خدم الدولة خدمة جليلة تمحو ما مضى من سيئاته وعصيانه، ومهَّد السبيل لذلك أنه لَمَّا علم أن الباب العاليَ عين واليًا جديدًا بدلًا من الجزائري
١ قام في الحال وأطلق خسرو باشا — وكان سجينًا — ليتولى الأمور حتى يصل الوالي الجديد، ولكن الجند لم يرضَوْا بأي حالٍ إعادة تنصيبه واليًا؛ فاضطُر محمد علي بعد إطلاقه بثلاثة أيام أن يُسفِّره إلى رشيد، ومن ثَمَّ أبحر إلى القسطنطينية بعد أن أظهر له عجزه عن حمايته.
وبعد هذا الحادث بزمن وجيز وصل «أحمد خورشيد باشا» الوالي الجديد، واعترف بتوليته كل الجيش من تُركٍ وألبان، وأذعنوا له بالطاعة، ولكنه أظهر بعد فترة من الزمن أنه والٍ ضعيف الإرادة غير كفء لهذا المنصب، وعجز كسابقيه عن دفع مرتب الجند والأتراك، فرجعوا إلى السلب والنهب. أما محمد علي فاتبع الطريق الأقصد، ومنع أتباعه من الألبانيين من مصادرة الأهالي، بل كان بالعكس يجتهد في حمايتهم من ظلم الأتراك وعسفهم. ولَمَّا رأى الأهالي ما ارتكبه الجنود ثاروا على الوالي والتجئوا إلى محمد علي ليوقف هذه المظالم، فأمَّنهم على حياتهم وأموالهم بشرط أن يدفعوا له من المال ما يقوم بحاجة أتباعه من الألبانيين. وفي هذه الأثناء جاء إلى خورشيد باشا الوالي أمر سلطاني باستدعاء الألبانيين وقائدهم محمد علي، فتأهب هو وجنده للرحيل من الديار المصرية، فرجاه كبار الأمة وعلماؤها في البقاء بمصر خوفًا من تسلط الأتراك وبطشهم، فقبل ذلك منهم وأبى الرجوع. وفي هذه الأثناء جمعت المماليك جموعها على مقربة من المنية للإغارة على القاهرة، فولى خورشيد محمد علي قائدًا على الجيش الذي أعده لمحاربة المماليك، فحاربهم في عدة وقائع لم تكن فاصلة. وفي خلال هذه الحروب وصل جيش من الدلاة من قِبل الباب العالي أكثر همجية وأبشع حالًا من الجيش الذي في داخل البلاد ليحل محل الألبانيين، فلما علم محمد علي بذلك ظن أنه وقع بين نارين، فقفل راجعًا إلى القاهرة وواجه الجيش الجديد جهة «البساتين» و«دير الطين»، وأخبرهم أنه لم يحضر لخلاف ولا عصيان، ولكن لطلب النفقة والمئونة، وأنه يرمي معهم إلى غرض واحد وهو تأييد الوالي والسلطان وإبادة المماليك؛ فانخدعوا بقوله، وأفسحوا له الطريق، فدخل القاهرة دخول المنتصر بعد أن اتفق مع الدلاة وأجزل لهم العطاء والهدايا، فأصبحوا معه على الوالي، وسمح لهم بالذهاب في طول البلاد وعرضها، يجمعون الضرائب ويأكلونها.
ولما عاثت جنود الأكراد — الدلاة — في الأرض فسادًا قام الأهالي في وجه خورشيد، وطلبوا من محمد علي أن يحميَهم ويكون الواليَ عليهم، فقبل ذلك وشنَّ الغارة على الوالي، فاعتصم هذا بالقلعة، ولما لم يجد له وسيلة يتخلص بها من محمد علي اجتهد في الحصول على عهد من الباب العالي بتنصيب محمد علي واليًا على جدة، فلم يلتفت محمد علي لهذا التنصيب، وحاصر خورشيد باشا في القلعة، وأطلق عليها المدافع إطلاقًا ذريعًا، وذلك في (صفر سنة ١٢٢٠ﻫ/مايو سنة ١٨٠٥م).
وحينئذٍ اجتمع علماء البلد ووجهاؤها وأقاموا محمد علي واليًا على مصر، فقام إليه الشيخ الشرقاوي و«السيد عمر مكرم» نقيب الأشراف وألبساه «الكرك» إيذانًا بالولاية. وكان في يد السيد عمر أمر العامة في جميع أنحاء مصر، لا يعصون له أمرًا؛ فأيد أمر محمد علي بنفوذه وجاهه أكثر من ٤ سنين تأييدًا لم يقم به أحد مثله، وأرسل العلماء رسولًا إلى الباب العالي ليلتمس العفو عما فرط منهم في حق الوالي ويرجو اعتماد تنصيب محمد علي خلفًا له، فعلم السلطان من ذلك مقدار ميل الأهلين لمحمد علي، وأيقن أنه أصبح صاحب الكلمة العليا في مصر، فوافق على تنصيبه واليًا عليها في (ربيع الآخر سنة ١٢٢٠ﻫ/يوليو سنة ١٨٠٥م). ولما علم خورشيد باشا بهذا النبأ سلَّم له القلعة وتخلى عنها.