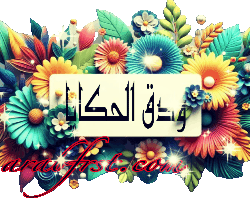جلستُ على الكرسي الخشبي، الكرسي الذي لم يختَرّه أحدٌ إلا وأثّر فيه بيده أو بمشيته. خدوشه كانت كالخرائط التي تحكي عن رحيل الزوار، عن حملٍ أثقلهم، عن كلماتٍ لم تُقال، عن دموعٍ تركت أثرها بين الأخشاب. جلستُ وأنا أراقب البلور أمامي، البلور الذي يعكس الوجوه مشوشةً، كما لو كانت أرواح الناس غريبة عن أجسادهم. الشتاء هذا العام كان قاسياً، عظامي لم تعد تحتمل برودته، والقهوة تتصاعد من فنجاني بخجل، بخارها يختنق قبل أن يلامس الهواء.
أحسستُ، فجأة، أن كل شيء حولي يتحدث إليّ بلغةٍ غريبة: الكرسي، الفنجان، البلور… وكأن المدينة كلها تعترف بأنني هنا، أستمع، أتنفس، وأحاول فهم نفسي قبل فهم المطر.
حملتُ حقيبتي، وتركت الفنجان يدفئ نفسه، كما لو كان يعرف أنني سأرحل. خرجتُ من المقهى، وأخذت الطريق إلى المنزل، الطريق الموحل الذي يذكّرني بأن كل خطوة، مهما كانت صغيرة، تُكتب في ذاكرة الأرض.
المطر لم يكن مجرد ماء، بل كان كتابًا مفتوحًا على وجهي، كل قطرة تكتب قصة قديمة، قصة كنت أحاول نسيانها منذ سنوات. انزلقت قدماي، وسقطت في حضن الوحل البارد، وأثناء محاولتي النهوض، تذكرت يومًا من أيام تشرين، يوم كنت في الرابعة عشرة، أعمل عند سيدة عجوز كي أتمكن من الدراسة.
ذلك اليوم تأخرت في العودة للمنزل، وكنت أعرف أن الانتظار طويل… لكنه لم يكن يستحق الصدمة التي تلقيتها. حين فتحت الباب، كان زوج أمّي واقفًا هناك، الصوط في يده، وجهه مشحون بالغضب الميكانيكي الذي لا يعرف الرحمة. لم يكن هناك وقت للحركة، لم يكن هناك مساحة للصراخ، لم أكن أستطيع الهرب. كل ضربة كانت تتعدى جسدي لتصل إلى شيء داخلي لم أستطع تسميته حينها، لم أكن أعرف أن الجسد يُصاب والروح تُحاصر في آن واحد.
الوحل تحت قدمي الآن، والبرد يلسع عظامي، ودموعي تتساقط مع المطر… كل شيء يعود لي كما لو أن الأرض نفسها أرادت أن تذكرني بأن الألم القديم ما زال حيًّا في الداخل. كنت أرفع رأسي قليلًا، أستمع لصوت المطر، وأشعر بأنه يهمس: لقد نجوتِ من ذلك اليوم، لكن روحك تحتفظ بكل ما حدث.
كل خطوة جديدة بعد الانزلاق، كل محاولة للنهوض، كانت معركة صامتة بيني وبين تلك الطفلة الصغيرة، الطفلة التي لم تستطع الدفاع عن نفسها حينها، والتي الآن تحمل حقيبتها وتخرج إلى المطر بلا خوف. أحيانًا، أرى انعكاس تلك الطفلة في وجهي في المرايا، في كل قطرة مطر على البلور، في كل خدش على الكرسي الخشبي.
ضحكت، ضحكة مبحوحة، وكأنني أختلطت أنا والطفلة والمطر والوحل في مشهد واحد لا يفصل بين الماضي والحاضر. فهمت حينها أن السقوط ليس النهاية، وأن الانكسار ليس ضعفًا، بل طريقة الأرض لتعلمني أن أستمر، أن أمشي، أن أتنفس.
دخلت المنزل، الأبواب المبتلة بصوت المطر وهي تخطو فوق الأرض المبللة، كل خطوة تصدر صدىً يذكّرني بأنني ما زلت على قيد الحياة، وأنني أمتلك القدرة على الحركة، حتى لو كان الجسد متعبًا، حتى لو كانت الذكريات ثقيلة كالوحل الذي تركت خلفي.
توجهت إلى الغرفة الصغيرة في آخر الممر، الغرفة التي لم تعرف ضوء الشمس إلا نادراً، لكنها تحمل دفءً غريبًا رغم عتمتها. هناك، على السرير، كان جسد الرجل الهرم، زوج أمّي، المسكين الذي سقط من علو وتركه أبناءه بلا رعاية، مشلولاً رباعيًا، لا يقدر على الحركة إلا بعينيه، تلك العيون التي لم تعرف إلا ايلامي منذ سنوات.
وضعت له الطعام أمامه، الصحن الصغير البسيط، ووقفت لأحدّق في عينيه مطولاً. كانت عيناه تقولان أكثر مما تستطيع الكلمات قوله: الخوف، الندم، الحزن، الوحدة… دموعي انهمرت بلا تحذير، تجرّ على وجنتيها كما لو كانت المطر الذي غسّلني قبل قليل، وغسّل عني جزءًا من نفسي الثقيلة.
كنت أفعل هذا كل يوم، نفس المشهد، نفس العادة... أطعم، أنظر، أبتسم قليلًا، وأسمح للدموع أن تهبط على وجهي وعلى كتفيه، أحيانًا أستمع لصوت أنفاسه الثقيلة، أحيانًا أسمع صوته المبحوح وهو يصرخ بصمت، أحيانًا أرى في عينيه انعكاس نفسي الصغيرة، الطفلة التي ضربها زوج أمها منذ سنوات، والتي اختبأت خلف جسدها لتعيش، لتعتني، لتغفر بلا كلام.
أعرف أنه يشعر بالذنب لأنه أصبح عبئًا، أعرف أنه يتمنى لو أن أحدًا غيري كان موجودًا، لكنني هنا، كل يوم، أحتضن الصمت بدل الكلمات، وأمد يدي، وأضع الطعام، وأترك الدموع تقول ما لم نجرؤ على قوله جميعًا.
وفي تلك الغرفة، بينما المطر يواصل الرقص على سطح المنزل، شعرتُ بارتباط الزمن كلّه في لحظة واحدة... الطفلة، الشابة، المرأة، الرجل العجوز… جميعًا يجلسون هنا، في هذه الغرفة الصغيرة، يختلطون بالوحل، بالمطر، بالدموع، وبالحياة نفسها، حياة مستمرة رغم كل الانكسارات، حياة تجعل القلب يتعلم الصبر، والرحمة، والحب الصامت الذي لا ينسى.
جلستُ على حافة السرير، أضع يدي على صدر الرجل، أسمع أنفاسه الثقيلة تتماوج مع صمت الغرفة، ومع صوت المطر على السطح. كل شيء حولنا كان يتنفس: الجدران، الأرضية، الصحن الفارغ بعد الطعام، حتى الذكريات التي كانت تختبئ في الزوايا، كلها تتنفس معنا.
غريبة هي الحياة، فكرتُ: كيف تجمع الألم والحنان في نفس اللحظة، كيف تجعل الطفل الضائع يتحول إلى المرأة التي تعطي بلا حدود، كيف تجعل السقوط في المطر يُعيدك إلى لحظات الطفولة التي كنت تعتقدين أنك تركتها خلفك؟ كل شيء هنا، كل شيء موجود، لكنه ليس عبئًا، بل درسًا، درسًا في الصبر، في الحب الصامت، في القدرة على التحمل، على الاستمرار رغم كل الخيبات.
حدقت في عينيه مطولًا، لم أقل كلمة، فقط تركت دموعي تنساب، تلمس وجنتيه، تمسح عننا آثار الوقت، وتترك مكانها لدفء غريب، دفء يذكّرني بأننا، رغم كل الانكسارات، رغم كل سقوط، ما زلنا قادرين على النهوض، على الحب، على الرحمة.
المطر توقف قليلًا، لكن رائحته بقيت معلقة في الهواء، كأن المدينة نفسها تراقبنا، وتهمس لنا: لقد فعلتِ ما يجب أن يُفعل… والآن، عودي لنفسك، عودي لحياتك، واحتفظي بهذا الصمت ككنزٍ حيٍّ، كخيطٍ يربط الماضي بالحاضر، وكجرسٍ يذكر بأن الرحمة هي أسمى ما يمكن أن نمنحه للعالم ولأنفسنا.
أغمضت عيني، وجلستُ أستمع… لصوت المطر البعيد، لصوت أنفاسي، لصوت قلبٍ يعرف أنه رغم كل السقوط، كل الألم، كل الدموع… ما زال ينبض، ما زال مستعدًا للحياة، للرحمة، للحب الصامت الذي لا يموت.
النهاية ....