-
- إنضم
- 23 فبراير 2023
-
- المشاركات
- 68,844
-
- مستوى التفاعل
- 26,726
- مجموع اﻻوسمة
- 32
حين دفنت واقفة
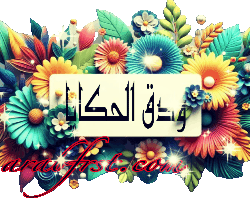
منذ البدء، كانت الكلمات سكاكين تُسنّ على رقبتها.
"لا ترفعي صوتكِ."
"لا تنظري كثيرًا."
"لا تسألي."
"البنات لا يُكملن التعليم."
تعلّمت أن تُنصت، لا لتفهم، بل لتنجو.
حلقاتها المدرسية لم تكن في صفوفٍ باردة بل على أرض الغرفة، كتاب ممزق، وسبّابة ترتجف، تُشير إلى جملة: "المعادلة تحتاج لحل."
لكن لا أحد أراد الحل.
كلهم أرادوا الصمت.
كان الصمت مطلبًا يوميًا، مثل الخبز والماء.
كانت تفهم.
تفهم أكثر مما يجب.
وهذا وحده، كان خطيئة.
الذكاء لم يكن نعمة، بل وشاية.
وكل من تفهم، تُتهم.
سُلّمت كطرد بريدي إلى رجلٍ لا يعرف سوى وجه يديه.
الوجع كان توقيتًا يوميًا: الساعة السابعة صراخ، الثامنة ضربة، التاسعة صمتٌ كثيف كجدران الزنزانة.
قالت لنفسها: "الليل ليس موتًا، الليل تمرين على الرحيل."
ثم رحلت.
لا بد للنجاة من شكل، ولو كان الفرار.
في المدينة، لم تسألها الأرصفة عن اسم أبيها، ولا طلبت منها العفة كورقة هوية.
في المدينة، الشوارع عمياء، لكنها أقل قسوة من عيون أهلها.
عملت، درَست، جفّت فيها أنهار النوم، وبقيت تسير.
كلما تعثّرت، نهضت كأن الأرض لا تستحق دموعها.
جسدها ينهار بين حين وآخر، لكنها لم تكن جسدًا فقط.
كانت فكرة، رغبة، تمرّدًا صغيرًا ينمو في الظل.
صارت طبيبة.
لا لأنهم آمنوا بها، بل لأنها آمنت بنفسها رغماً عنهم.
يدها على جسد مريض، عيناها على جرح لا يُرى.
قيل عنها إنها اليد التي تشفي ما لا يُقال، الذاكرة التي تُنقذ الآخرين من ذاكراتهم.
وكان كل مريض يرى فيها مرآةً لا يريد أن يحدّق فيها طويلًا.
لكنها لم تكن مرآة، بل شاهدًا، على ما يمكن أن تكونه امرأة حين تُترك وشأنها.
ثم جاء الحنين.
ذاك الحيوان الأبكم الذي ينهش دون أن يُصدر صوتًا.
عاد التراب يناديها، لا بل يجرّها من قدميها.
قال لها صوتٌ ما: "عودي، تغيّروا."
لكن الأصوات كاذبة.
الوطن، في كثير من الأحيان، ليس حنينًا، بل فخًّا مموّهًا برائحة الخبز القديم.
عادت.
كانت تحمل شهادتها كما تُحمل راية في معركة ضائعة.
كانت تبتسم بحذر.
البيوت ما زالت كما هي، مائلة، مغمضة.
الوجوه كما هي، مغلقةٌ على جملة واحدة: "جاءت."
كأنها لم تكن من لحم ودم، بل زلة قديمة يجب محوها.
لم يمنحوها حتى فرصة الحديث.
لم يسألوها كيف نجَت.
لم يسألوها لماذا تعود.
الأسئلة حرام، والنساء الراجعات خَطَر.
كأنهم كانوا بانتظارها.
كأنها عادت لتموت، لا لتصالح.
جاءوا بالكفن.
لم يكن أبيض.
كان رماديًا، كثيفًا، يشبه ثوب المساء الأخير.
اقتادوها إلى التل.
تلك البقعة التي لا تُدفن فيها النساء، بل تُسجَن واقفة.
في ذلك المكان، لا يوجد تراب يغطي الجسد، فقط صمت يغطي المعنى.
صرخت.
رفعت شهادتها.
قالت: "أنا امرأة صنعت نفسها من شتائمكم."
لكنهم لا يفهمون اللغة.
يفهمون فقط قانونهم الأعمى: التي تهرب تُدفن، التي تنجح تُمحى، التي تفكر تُشنق داخل رأسها.
دُفنت واقفة.
لا شاهد، لا اسم، لا مغفرة.
وفي اللحظة الأخيرة، لم تكن تبكي.
كانت تحدّق في السماء، كأنها تُراهن على سطر أخير، لم يُكتب بعد.
وربما، في سماءٍ أخرى، ستجد يدًا لا تَجلد، بل تكتب معها جملة واحدة:
"أنا هنا. لم أنتهِ."
مرّت سنوات.
غاب مَن دفنوني، وتغيّرت ملامح التلّ، إلا أنا.
ظللتُ هناك، في الأعلى، لا أطلب الرحمة، ولا أهب الغفران.
وفي صباحٍ رماديّ، حيث لا أحد يزور، ولا أحد ينتظر، حدث ما لم يتوقّعه أحد.
من شقّ في الصخر نبتت شجرة.
نحيلة، لكنها عنيدة.
جذعها مائل كأنّه يسند ذاكرة، وأغصانها تتلوّى نحو السماء كأصابع تصلي ضد الصمت.
ولم تكن خضراء.
كانت بنفسجية.
بنفسجية كما الحزن الصامت، كما كدمات الروح، كما الرسائل التي لم تُكتب.
قالوا:
"من أين جاءت؟"
"لا أحد زرعها."
"لا مطر هنا، ولا ظل."
لكنّها نَمَت.
نمت كما تنمو الحكايات الممنوعة، كما ينمو الرفض في قلبٍ صغير.
البنات في القرية صرن يتسللن ليلًا إلى التلّ،
يتلمسن جذع الشجرة كأنّه جلدٌ يعرفهن،
يتنفسن رائحة زهورها كأنّ فيها شيئًا من دمعهنّ القديم،
ويقلن همسًا:
"هنا امرأة لم تمت."
وبدأ البعض يهمس، ثم يهمس أكثر:
أنّ من يقف طويلاً في حضرة البنفسج،
يسمع صوتًا يأتي من الجذور:
"لا تعودي إلى قفصك."
"لا تسامحي الظلم بالصمت."
"لا تُدفني واقفة."
وهكذا، صارت الشجرة مزارًا.
لا يحمل اسمًا،
ولا يحتاج شاهدًا.
يكفي أن تتفتح زهورها في وجه الريح،
حتى تعرف كل فتاة:
أن من قاومت حتى النهاية،
لم تُمحَ، بل تحوّلت.
من جسد إلى شجرة،
من صوت إلى ظلّ لا يُكسر،
من ذكرى إلى بذرة،
تُنبت ثورة... بنفسجية.
النهاية.....
اسم الموضوع : حين دفنت واقفة
|
المصدر : قصص من ابداع الاعضاء


